توطئة:
في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها القرن الأفريقي كثّفت إثيوبيا مؤخراً جهودها لإعادة إحياء قضية الوصول إلى البحر الأحمر من منظور استراتيجي يبرر مطالبها بالحصول على منفذ بحري—سواء عبر طرح جدل قانوني وتاريخي حول حقها في الوصول إلى الساحل سواء عبر السبل الدبلوماسية أو عبر طرح مبررات اقتصادية لهذا الطموح. ورغم تنوع هذه السرديات من الادعاءات التاريخية إلى المبررات الاقتصادية فإنها تعكس في جوهرها الأزمة الداخلية العميقة التي تعانيها إثيوبيا ومحاولتها إعادة صياغة الديناميكيات الإقليمية لصالحها.
وفي مواجهة هذه الادعاءات قام عدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين الارتريين تحت مسمى فرقة عمل البحر الأحمر بإعداد ورقة دراسات بحثية تحليلية (السيادة الإريترية وسعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الاحمر) الهدف منها تفنيد الأسس التاريخية والقانونية والسياسية للحجج الإثيوبية مؤكدين على السيادة المطلقة لإريتريا على سواحلها استناداً إلى الحقائق التاريخية والمعاهدات الدولية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الجهد البحثي في كشف تناقضات السردية الإثيوبية إلا أن القراءة المتأنية لهذه الأوراق البحثية تكشف عن غياب رؤية استراتيجية شاملة تخرج الورقة البحثية عن إطار الجدل التاريخي لتتناول الأبعاد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية للقضية. فالخطاب الأكاديمي وحده لا يكفي لمواجهة الطموحات التوسعية ما لم يتم دمجه في استراتيجية وطنية تعالج نقاط الضعف الداخلية التي سمحت لمثل هذه الادعاءات بالظهور والترويج لها إقليميًا ودولياً.
ومن أبرز الإشكاليات التي تجاهلتها هذه الدراسة عدم الإشارة إلى السياسات الفاشلة للنظام الإرتري في استثمار الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي للبلاد وتحويل موانئها إلى مراكز نفوذ اقتصادي وسياسي مما أتاح المجال لإثيوبيا لتقديم نفسها كدولة “مظلومة” تسعى للحصول على منفذ بحري إضافةً إلى ذلك لم تقدم الدراسة البحثية أي تصور حول كيفية توظيف هذا الجهد البحثي ضمن استراتيجية سياسية أوسع يمكنها نقل قضية البحر الأحمر من مسألة أكاديمية إلى قضية رأي عام إقليمية ودولية.
معالجة قضية البحر الأحمر لا تقتصر فقط على الدفاع عن السيادة الإرترية في مواجهة الطموحات الإثيوبية بل يجب أيضاً مواجهة التحديات الداخلية المرتبطة بسوء إدارة الموارد الوطنية. فقد أدى هذا الفشل الإداري إلى عزلة إريتريا عن المجتمع الدولي وحرمانها من القدرة على بناء تحالفات استراتيجية تعزز مكانتها الإقليمية وبالتالي فإن أي قراءة نقدية للورقة البحثية التي لا تأخذ بعين الاعتبار غياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة يضعف تأثير هذا الجهد الأكاديمي الذي يقتصر على تفنيد المزاعم الإثيوبية نظرياً دون ترجمتها إلى خطوات سياسية ملموسة.

السرديات الإثيوبية: تلاعب بالتاريخ وهروب من الواقع
تعتمد إثيوبيا في مطالبها منفذ على البحر الأحمر على سرديات تاريخية انتقائية تستند إلى وقائع قديمة لتبرير طموحاتها الجيوسياسية. وتتمحور حججها حول فترات تاريخية محددة مثل تأثير مملكة أكسوم على أجزاء من إريتريا في الحقب السابقة متجاهلةً بذلك حقيقة أن مفهوم الدولة القومية الحديثة يختلف جذرياً عن البنية السياسية القديمة. كما تتجاهل هذه الادعاءات حقيقة أن إريتريا لم تكن في أي مرحلة من التاريخ الحديث امتداداً إثيوبياً بل كانت كياناً سياسياً مستقلاً تشكّل نتيجةً لديناميكيات داخلية وخارجية واكتسب استقلاله الكامل والمعترف به دولياً من خلال استفتاء وطني.
والمثير للاهتمام أن هذه الادعاءات تظهر في سياق إقليمي ودولي متغير يعيد تشكيل موازين القوى في القرن الأفريقي. إذ تحاول إثيوبيا استغلال أزماتها الداخلية السياسية والاقتصادية عبر إحياء مزاعمها التاريخية والاستفادة من التفاعلات الإقليمية. وبالتالي، فإن مواجهة هذه الادعاءات لا ينبغي أن تقتصر على دحضها تاريخياً بل يجب أن تمتد لفهم السياقات السياسية التي تحيط بها والعمل على بلورة موقف إرتري موحد ومتكامل يُخرج القضية من إطار الدفاع إلى إطار الهجوم الاستراتيجي.

الحقائق الجيوسياسية وفشل إدارة النظام الإرتري
في الوقت الذي تعزز فيه إثيوبيا طموحاتها الجيوسياسية وتطالب بموقع لها في البحر الأحمر أخفق النظام الإرتري في استغلال الفضاء الاستراتيجي للبلاد وهو أحد أكبر الإخفاقات السياسية والاقتصادية في تاريخه. فبدلًا من استثمار الموانئ الإرترية وتحويلها إلى مراكز استراتيجية تعزز المكانة الجيوسياسية للدولة انتهج النظام سياسة انعزالية لم تستفد من الموقع الجغرافي المهم. وفي الوقت ذاته برزت دول مجاورة مثل جيبوتي كمراكز بحرية رئيسية في المنطقة ما أدى إلى تعميق الفراغ الاستراتيجي الذي تركته إريتريا. ونتيجةً لذلك أصبحت إثيوبيا تعتمد بشكل شبه كلي على هذه البدائل مما منحها ميزة إضافية في التفاعلات الإقليمية.
هذا الفشل الاستراتيجي لم يتسبب فقط في خسائر اقتصادية بل وفر أيضاً فرصة لإثيوبيا لتبرير طموحاتها البحرية كحاجة “اقتصادية ملحّة”. فالمشكلة الحقيقية ليست في عدم امتلاك إثيوبيا منفذاً بحرياً مباشراً بل في فشل النظام الإرتري في استثمار هذا الاحتياج الإثيوبي كورقة تفاوضية تعزز المكانة الإقليمية لإريتريا. وبدلاً من ذلك ترك النظام الارتري الباب مفتوحا أمام السردية الإثيوبية التي تربط احتياجاتها الاستراتيجية بخطاب أمني توسعي. وهنا يتجلى غياب البعد الاستراتيجي في الطرح الأكاديمي لهذه الدراسة البحثية حيث لم تتناول هذا البعد الداخلي للقضية ولم تعالجها وتغفل حقيقة أن السيادة لا تُحمى فقط عبر الخطاب السياسي بل من خلال سياسات اقتصادية واستراتيجية تجعل من إريتريا لاعباً إقليمياً رئيسياً بدلاً من أن تبقى مجرد مساحة جغرافية في حسابات الآخرين.
غياب الفاعلية السياسية في الخطاب الأكاديمي
تشكل هذه الأطروحة البحثية مساهمة أكاديمية مهمة حيث تقدم تفنيداً دقيقاً للادعاءات الإثيوبية ومع ذلك تبقى محدودة ضمن الإطار الأكاديمي الذي يختلف عن دور الفاعلين السياسيين الذين يقع على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن السيادة الوطنية. فلا يمكن مناقشة مسألة السيادة بمعزل عن الحراك السياسي فالخطاب الأكاديمي مهما كان دقيقاً ومؤسساً على حقائق تاريخية يظل محدود التأثير ما لم يُدمج في استراتيجية وطنية شاملة تشمل القوى السياسية الإرترية بمختلف أطيافها.
ومن أبرز أوجه القصور في هذه الدراسة أنها تعاملت مع قضية البحر الأحمر من منظور علمي بحت دون أن تربطها بالسياق السياسي الأوسع الذي تتحرك فيه ودون أن تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى تأثير هذا الطرح البحثي على صناع القرار الإرتريين أو المعارضة السياسية أو حتى المجتمع المدني. كما أنها لا تقدم تصوراً حول كيفية توظيف نتائجها كأداة دبلوماسية في الحوارات الإقليمية أو كوسيلة لتعزيز المكانة الإرترية في المحافل الدولية. ونتيجةً لذلك تبدو وكأنها مجرد حجج قانونية تفتقر إلى آليات التنفيذ السياسي الفعّال.
إضافةً إلى ذلك يتعامل النظام الإرتري نفسه مع قضايا السيادة بمواقف متناقضة حيث فشل في استغلال المكانة الاستراتيجية للبلاد لتعزيز نفوذها الإقليمي واتبع سياسات انعزالية جعلت من إريتريا لاعباً ثانوياً في المنطقة. وفي هذا السياق ورغم الأهمية الأكاديمية للأطروحات البحثية إلا أنها تفتقد لنقاش جوهري حول كيفية إسهام السياسات الحاكمة للنظام الإرتري في خلق بيئة مكّنت إثيوبيا من طرح مثل هذه الادعاءات.
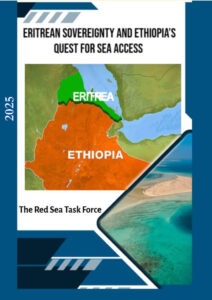
علاوة على ذلك فإن المعارضة الإرترية التي يفترض أن تكون الحصن الأول في الدفاع عن القضايا السيادية لم تحظَ بأي ذكر في الورقة وكأن الصراع حول البحر الأحمر مسألة قانونية محضة وليست قضية سياسية تتطلب استراتيجيات مواجهة متعددة المستويات. ورغم الضعف الذي تعاني منه المعارضة إلا انها تبقى عنصراً مهماً في صياغة مستقبل إريتريا السياسي وكان ينبغي أن تكون جزءاً من أي نقاش استراتيجي شامل في مثل هكذا قضايا حساسة . الفشل في إدماج الفاعلين السياسيين في هذا النقاش يعكس إشكالية أعمق تتعلق بالقطيعة بين التحليل الأكاديمي والواقع السياسي الإرتري حيث لا تزال السيادة تُناقش كقضية نظرية بدلًا من أن تكون مشروعا وطنياً يتطلب استراتيجيات واضحة للدفاع عنها.
لقد كان من الضروري أن تتضمن الورقة البحثية طرحاً لكيفية تفعيل دور القوى الوطنية في مواجهة الادعاءات الإثيوبية سواء عبر صياغة خطاب سياسي موحد أو من خلال تحرك دبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي أو عبر استثمار الإعلام لإيصال الرسائل الصحيحة إلى المجتمع الإقليمي والدولي. لكن بدلاً من ذلك اكتفت الورقة بتقديم معالجة أكاديمية جعلت من تفنيد الادعاءات الإثيوبية هدفًا في ذاته دون أن تطرح آليات عملية تُترجم هذا التفنيد إلى سياسات مواجهة فعالة على أرض الواقع.
الخاتمة
إن قضية البحر الأحمر تتطلب أكثر من مجرد دحض تاريخي وقانوني لمزاعم إثيوبيا بل تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة تربط بين البحث الأكاديمي والسياسة الاقتصادية والديناميكيات السياسية الفاعلة. فالمشكلة لا تقتصر على مواجهة الادعاءات الإعلامية أو التاريخية بل تعد جزءًا من صراع سيادي يستوجب إعادة تأهيل الأولويات الوطنية لمجابهة التحديات الإقليمية بفعالية.
لقد كشف الطرح الذي قدمه الأكاديميون والباحثون الإرتريون عن هشاشة الموقف الإثيوبي وافتقاره إلى أي أساس قانوني أو تاريخي متين لكنه في الوقت ذاته أبرز محدودية التأثير البحثي عند افتقاده لدمج مدروس ضمن سياق سياسي شامل. فالديناميكيات الأكاديمية المعزولة رغم دقتها وموضوعيتها تظل قاصرة ما لم تندمج في استراتيجية وطنية متكاملة تشمل كافة الفاعلين في إريتريا سواء في المشهد السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي.
وفي النهاية فإن الدفاع عن البحر الأحمر لا يقتصر على حماية الحدود بل يشمل صون السيادة الوطنية بجميع أبعادها وهو ما يفرض على جميع الإرتريين—من أكاديميين وساسة ومجتمع مدني—العمل ضمن رؤية موحدة تضمن حماية المصالح الوطنية والتعامل مع أي واقع جديد بما يعزز مناعة الدولة ويضمن استقرارها.






