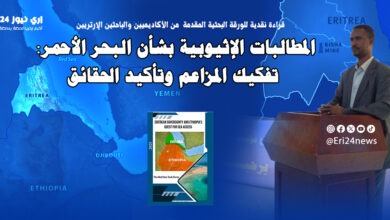تُمثّل الدولة القُطرية في العالم العربي والإسلامي أكثر من مجرد كيان إداري أو وحدة سياسية داخل حدود جغرافية محددة؛ إنها وعاء لصراعات رمزية ومعنوية تتصل بقضايا السيادة والشرعية والهوية، وتعكس في جوهرها تحوّلات عميقة في بنية التفكير السياسي العربي والإسلامي الحديث والمعاصر.
منذ انهيار الخلافة العثمانية وبروز الكيانات القُطرية المستقلة، وُلدت هذه الدولة في سياقٍ من التفكك السياسي والانقسام الثقافي والاجتماعي. وكان يُفترض أن تكون مرحلة انتقالية باتجاه بناء دولة حديثة تعبّر عن طموحات شعوبها، لكنها تحوّلت إلى بنية دائمة دون أن تُحسم إشكالياتها الكبرى، وفي مقدمتها:
- لمن تُمنح الولاءات؟
- من يُمثّل الأمة؟
- كيف تُعرّف العلاقة بين الدين والسياسة؟
- وما مصدر الشرعية في ظل غياب عقد اجتماعي حقيقي؟
في قلب هذه المعضلة، يتواجه تياران فكريان متناقضان يسيران في مسارين متوازيين ظاهريًا ومتصادمين جوهريًا. فمن جهة، تتبنى التيارات الإسلامية موقفًا نقديًا جذريًا من الدولة القُطرية، معتبرة إياها ثمرة مباشرة لمشاريع التفتيت الاستعماري التي استهدفت تفكيك وحدة الأمة الإسلامية وتدمير مشروعها الحضاري. ويستند الإسلاميون إلى تصور وحدوي يتجاوز الحدود المصطنعة، ويدعو إلى استعادة وحدة الأمة سياسيًا وثقافيًا عبر نموذج بديل يتجاوز النموذج القُطري وارتباطاته المفروضة.
ومن جهة أخرى، تصدّرت النخب العلمانية ذات النزعة اليسارية مشاريع بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال، لكنها أخفقت على مدى عقود في تفعيل هذا النموذج بما ينسجم مع تطلعات شعوبها وقيمها التاريخية.
لقد شكّل فشل النخب اليسارية والقومية في إنتاج دولة عادلة تمثل الإرادة الشعبية وتُحقّق التنمية والتحرر، أحد أبرز أسباب الأزمة الحالية. فبدلاً من التأسيس لعقد اجتماعي جديد، تمّت إعادة إنتاج البنية السلطوية بصيغ قومية وشعارات تقدمية، سرعان ما تحوّلت إلى أدوات للضبط السياسي والتعبئة الأيديولوجية دون أن تُنتج تحولًا حقيقيًّا في بنية الدولة أو في علاقة الحاكم بالمجتمع. وقد أدّى هذا التناقض إلى تفاقم الفجوة بين مؤسسات الدولة والنسيج الثقافي والاجتماعي، وخلق أزمة تمثيل وهوية ما زالت تتفاعل حتى اليوم.
وفي هذا السياق، تبرز مقاربة البروفيسور جلال الدين محمد صالح كمفتاح لفهم التحوّلات التاريخية التي رافقت نشوء الدولة القُطرية، حيث يشير إلى أن عملية التفكيك المتعمّد للجامعة الإسلامية والترويج لقومية عربية مفرغة من بعدها الحضاري الإسلامي، لم تكن حدثًا عابرًا، بل شكّلت منعطفًا مفصليًا ساهم في خلق فراغ في الهوية استُغل لاحقًا لإعادة تشكيل المجال السياسي والثقافي للمنطقة بما يتوافق مع مصالح القوى الاستعمارية.

وهنا يُحدّد جذر الانقسامات الراهنة، سواء بين العروبة والإسلام، أو داخل العروبة نفسها التي أصبحت رهينة لتوترات أيديولوجية واصطفافات جغرافية متوارثة منذ ذلك الزمن. وقد نبّه جلال الدين إلى الدور المحوري لبعض نخب نصارى الشام، إضافة إلى الأتراك الكماليين، في صناعة هذه الانعطافة التاريخية عبر تقديم العروبة بديلاً عن الإسلام، وتفريغها من مضمونها الحضاري التراكمي.
إن ما بدأ كمواجهة فكرية بين مشروعين – الجامعة الإسلامية بوصفها حاضنةً لوحدة المسلمين، والقومية العربية كإطار بديل – انتهى إلى مشهد معقّد تحوّلت فيه القومية إلى وعاء هشّ تتنازع داخله الولاءات الطائفية والجهوية والمذهبية، فيما عجزت الدولة القُطرية عن بناء فضاء جامع يُعيد صياغة العلاقة بين الهوية والدولة والمواطنة.
وفي ضوء هذا التحليل، فإن تجاوز أزمة الدولة القُطرية يتطلب مراجعة نقدية عميقة لمفهوم الدولة ذاتها، وإعادة التفكير في مشروعيتها وبنيتها وتمثيلها وهويتها، بما يتجاوز المقاربات الصدامية بين الإسلاميين والعلمانيين، نحو رؤية مركّبة تأخذ في الحسبان تعقيدات الواقع وتعدّد مستويات الانتماء.
وختامًا، فإن أزمة الدولة القُطرية في العالم العربي والإسلامي ليست أزمة شكل أو إدارة فقط، بل هي أزمة بنيوية تتعلق بجوهر النموذج ذاته، ومصدر شرعيته، وموقعه من المجتمع وقيمه. والتحدي الأكبر يكمن في إعادة التفكير في مفاهيم السيادة والهوية والتمثيل بعيدًا عن القوالب الغربية الجامدة أو الاستدعاءات التاريخية المتكلّسة.
ما تحتاجه المنطقة اليوم هو مشروع حضاري جديد، ينطلق من نقد جريء للتجربة الحديثة، ويُعيد وصل ما انقطع بين الدولة والمجتمع، بين السياسة والقيم، بين المشروع الوطني والانتماء الحضاري. وفي هذا السياق، تصبح إعادة قراءة الدولة القُطرية ومآلاتها، ليس فقط ضرورة فكرية، بل شرطًا أساسيًا لتجاوز مأزق الانسداد السياسي، والخروج من دائرة الانهيارات المتتالية نحو أفق جديد من الحرية والكرامة والسيادة الفعلية.